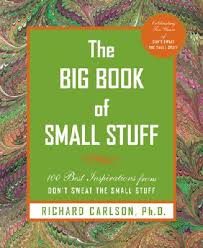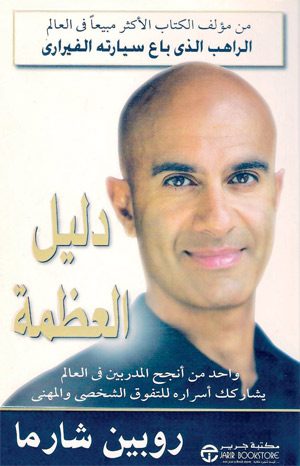قراءة
في كتاب
الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان
للأستاذ الدكتور عبدالوهاب المسيري
الكتاب الذي نَحْن بِصَدد مُراجعته، وتَسْليط الضَّوء عليه، يُمثِّل
بحقٍّ قراءةً نقديَّة لاتِّجاه فلسفي، سادَ الواقعَ المعاصر في أصقاعٍ كثيرة من
المَعْمورة، وأضحى قِبلة النَّاس اليوم - إن صحَّ التعبير - بسبب ما حقَّقه - في
الظاهر - من ثِمار ماديَّة، وتقدُّم علمي وحضاري، دفَع بالكثير من المُفكِّرين -
مِمَّن ينتسب إلى هذه الأمَّة - إلى الدَّعوة لتبنِّي أمثال هذه الاتِّجاهات،
وجَعْلها أساسًا فكريًّا وعقائديًّا ومنهجيًّا تقوم عليه الحضارة الإنسانيَّة
اليوم، وانساقَ معها الكثير من المُثقَّفين والكتَّاب إلى درجة قَبولِها
والتَّماهي فيها، بل وأفضى إلى تبَنِّيها من قِبَل بعض من تسنَّم السُّلطة في
البلاد الإسلاميَّة، وهذا جعلَها سائدةً في الأوساط الرَّسْمية، ولعلَّ التجربة
التُّركية تُمثِّل أبرز مثالٍ يتجلَّى في هذا السِّياق؛ لكونه أضحى نظامًا يتبنَّى
المنهجيَّة العلمانية، ويُنافح عنها بقوَّة على مدى عقودٍ متطاولة من القرن
الماضي، ولا زال؛ على الرغم من تصاعد أسهم الإسلاميِّين فيها.
هذه الدِّراسة ينبغي النَّظر إليها من
زاويتين متلازمتين:الأولى: من جهة واضعها، والثانية: من حيث موضوعُها الذي دارت
معه:
أمَّا بالنسبة لواضعها فهو الأستاذ
الدكتور عبدالوهاب المسيري - رحمه الله - ولا حاجة بنا أن نستعرض جوانب من حياته؛
لأنَّ ثماره الفكريَّة، وجهوده المعرفيَّة، ومؤلفاته الموسوعيَّة ناطقةٌ بِما
يُستغنَى عن بيانه في هذا المقام، وشاهدةٌ على ذلك البحر الزَّاخر من أفكاره، مما
حَدا ببعض المفكِّرين المعاصرين إلى وصْفِه بأنَّه صاحب مشروعٍ حضاري يقلُّ نظيره
في واقعنا المعاصر، واليوم وقد قضى هذا الجبَل وأفضى إلى ربِّه، حريٌّ بنا ونحن
بِصدَد تسليط الأضواء على بعض الكتُب أن نَجْعل لهذا العَلَم نصيبًا منها - وما
أقلَّه! - كجزءٍ من حقِّه علينا أن نُظهِر فيه فِكرَه وجهده، ونُعْمل فيه بصرَنا
وفِكرَنا، قاصدين تبصير الأمَّة بِما ينبغي الاهتمامُ به، وتوجيهها الوجهة
المنهجيَّة الصحيحة، وأمَّا من حيث موضوعُها، فهي دائرة بين عنوانين كبيرين:
الفلسفة المادِّية - الإنسان، ولو وقَفْنا قليلاً عندهما، لأَدْرَكْنا أن الإنسان
فيهما يمثِّل الفاعل والمفعول في الوقت نفسه، فالفلسفة الماديَّة تمثِّل خلاصة
أفكار من قِبَل النُّخَب الفكريَّة الغربيَّة على مدى ثلاثة قرون وأكثر، قاصدةً
الخروج بالإنسان من أزماته الكبرى على مُختلف الأصعدة، وهو ما واجهَه الإنسانُ
الأوربِّيُّ تحديدًا بعد ذلك الصِّراع العقائدي المفتعَل بين الكنيسة والعلم،
وانتهى باندِحار الكنيسة وتَراجُعِها؛ لتكون معزولةً بين جدران صامتة، لا أثر لَها
في الواقع إلاَّ على المستوى الفرديِّ وفي أزمنةٍ يسيرة، وأمَّا صناعة الحياة
وتوجيهها، فتكون بأيدي أولئك النُّخَب الَّذين جعَلوا نُصْب أعينهم توجيهَ دفَّة
البشريَّة في تيَّار مادِّي بعيدٍ عن كلِّ ما يَمتُّ للدِّين بصِلَة - أعنِي به
دينَ الكنيسة - وقد يَستغرب البعضُ ويتَساءل:هل يمكن تبصيرُ الأمَّة بأمثال هذه
الكتُب، وبِمِثل هذه الأُطروحات؟ وقد سِيقَتْ في إطارٍ فلسفي يَخْتلف جذريًّا
عمَّا اعتادَه المسلمون في تنشئتهم المعرفيَّة والعِلمية؟
وقد يصحُّ هذا التَّساؤل في ذلك
الواقع الظرفيِّ الذي لَم يتلوَّثْ بأدران الفلسفة الماديَّة، ولَم تتمكَّن من
عقليَّة كثير من المسلمين كما هو حالُهم اليوم، أما وقد أضحَت الأُمَّة غائصةً في
الحداثة وما بعدها، وأضحى الموجِّهَ لها أولئك المفكِّرون الَّذين شكَّلوا عقليَّة
الغرب ودفعوه إلى أن يكون موجِّهًا لغيره، وقد تحقَّق لهم ما أرادوا فسيَّروا
حملات علميَّة وفكرية إلى العالَم الإسلاميِّ تحت مسمَّى الاستِشْراق، كان الغرض
منه دراسةَ أوضاع المسلمين، والتعرُّف عليهم عن قُرْب وإدراك مَواطن قوَّتِهم
وضعفهم، وقد كان المسلمون في ذلك الوقت أضعفَ ما يكون، ومن المعلوم - استطرادًا -
أنَّ المغلوب يتأثَّر بالغالب، كما قرَّر ذلك ابنُ خَلْدون، ولعلَّنا نستذكر في
هذا السِّياق ما قاله الأستاذ عمر عبيد حسنة أنَّ الاستِشراق كان في بداية أمره
يُشَكِّل عقليَّة الغرب، أمَّا اليوم فإنه أَضْحى موجِّهًا للأمَّة؛ من أجل نَزْع
ثقافتها وجعلها سائرةً في رِكَاب الغرب عقيدة وفكرًا ومنهجًا، وعِلمًا وعملاً.
إنَّنا اليومَ بِحاجةٍ إلى أمثال هذه
الدِّراسات المتعمِّقة في الفكر والمنهج الغربيَّيْن؛ لأنَّها تُمثِّل خلاصةَ
وثمرة عقلٍ غاصَ في أفكار الحضارة الغربيَّة، وأضحى - بعد أن كان متبنِّيًا لها -
ناقدًا قد أتى عليها من قواعدها ومنطلَقاتِها، وليس بالضَّرورة أن نكون مُتوافِقين
معه في كلِّ ما يكتب، ولكن حسبنا أن نُدرِك حاجةَ الأُمَّة إلى من يُبصِّرها بمنهج
غيرها؛ لتأخذ حِذْرَها، وتميز السبيل والطَّريق؛ ﴿ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ
وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأنعام: 55]، وكلٌّ مُيسَّر لما خُلِق له، آخِذين بنظر الاعتبار
أهميَّة الوقوف على ما ينفع الأمَّة حضارةً، ولا يتعارض معها شِرْعةً، وسوف نَسْلك
منهج التوصيف في قراءتنا لهذه الدراسة؛ كما هو شأن أمثال هذه المراجعات.
تُثير هذه الدِّراسة من خلال
منهجيَّتِها التحليليَّة جملةً من التَّساؤلات التي تشكِّل الإجابةُ عنها الوقوفَ
على حقائق المنهجيَّة الغربية في جوانبها المختَلِفة؛ (الفكريَّة، والعقائديَّة،
والاجتماعيَّة، والاقتصاديَّة، والسِّياسية... إلخ)، يُمكن حَصْرُها في الآتي:
• ما علاقة الإنسان بالمادَّة؟ وهل الإنسان كائنٌ مادِّي وحَسْب؟
• ما هو مفهومُ التَّفكيك الَّذي تدعو إليه الفلسفة المادِّية؟
• ما هي المرجعيَّة التي تشكِّل أفكار الإنسان؟ ويَرْجع إليها كلُّ
أساس فِكْري؟ وهل يمكن وَصْفها بالإطلاق؟
• هل يمكن تعميمُ قوانين العلوم الطبيعيَّة على العلوم الإنسانيَّة؟
وهل يُمكِن تفسير الظَّواهر الإنسانيَّة كميًّا كما هو الحال في العلوم
الطبيعيَّة؟
• لماذا تنكر الفلسفة الماديَّة النموذج الكُلِّي؟
• ما هي نظريَّة الحقوق الجديدة التي دعَتْ إليها الفلسفة الماديَّة؟
• ما هو دور القِيَم في الإطار الفلسفيِّ المادِّي؟
• هل استطاعَت الفلسفة الماديَّة إخراجَ الإنسان من أزماته؟
أوَّلاً - إشكاليَّة المفاهيم:
تنطلق الفلسفة الماديَّة في تفسير
ظاهرة الإنسان - حسب رؤيتها - من حقيقةٍ أساسيَّة، ماهيتُها أسبقيَّة الطَّبيعة
على الإنسان؛ ولذلك تُحاول التركيز على جانبِه المادِّي؛ فالإنسان موجودٌ مادِّي
متجِّسد، يُشارك غيرَه مِن المخلوقات في بعض الصِّفات، يَخْضع للقوانين الطبيعيَّة
وضرورات الحياة العضويَّة؛ باعتباره داخلاً في منظومةٍ من الآلِيَّات والحتميَّات
تَسْري على كلِّ مادِّي؛ كالحاجة إلى الطَّعام والشراب، والنَّوم والتناسل،
وغيرها، ولذلك - حتَّى يَسْهل رَصْدُه - لا بدَّ من الاعتماد على النَّماذج
المستمَدَّة من العلوم الطبيعيَّة، وعلى هذا الأساس تَطْرَح الفلسفة المادية
مفهومَ الإنسانية الواحدةِ الكامنة في الطبيعة؛ حيث ترى أنَّ الإنسان جزءٌ لا
يتجزَّأ من الطبيعة، خاضعٌ لقوانينها، كامنٌ فيها، ليست عنده القدرةُ على
تجاوُزِها، وهذا يقتضي بالضَّرورة أنَّ كل مشكلة تواجِه الإنسان يمكن تجاوزها
بالاستِناد على الواقع المادِّي، دون الرُّجوع إلى نماذج مُتجاوِزة لهذا الواقع؛
مِمَّا يَعني أنَّ الإنسان يُنظَر إليه في هذا الإطار على أنَّه مُساوٍ لغيره من
المخلوقات مِمَّن يُشاركه وجودَه المادِّي، وهذا يثير بدوره إشكاليَّة التَّسوية،
وهي من المفاهيم المتولّدة من المرجعيَّة المادية، وتَعني التَّساوِي بين كلِّ
المخلوقات؛ البشَر وغيرهم، مِمَّا يَعني الاقترابَ من حالة الطبيعة، والهجوم
الشَّرس على الحالة الإنسانيَّة، ويصبح عندئذٍ مقصده وهدفه التطوُّر المادي؛ حتَّى
يصبح مادَّة مَحْضة تَخْضع لقوانين الطَّبيعة لا يَستطيع تجاوُزَها، وفي هذا
السِّياق يَبْرز مَفْهوم التَّفكيك الذي تُؤصِّل له الفلسفة الماديَّة، ذلكم
المفهوم المُتجاوز للحقيقة البشريَّة الجامعة بين الرُّوح والمادَّة؛ بِما يَجعله
كائنًا متميِّزًا؛ لكونه يُمارس نشاطاتٍ تَتجاوز الإطارَ الماديَّ، بل عليه كما هو
الحال بالنِّسبة للقِيَم الدينيَّة والخُلقيَّة وغيرها.
فالفلسفة الماديَّة مِن خلال هذا
المَفْهوم نظرَتْ إلى الإنسان - مِن خلال مرجعيَّتِها المادية - على أنَّه عبارة
عن تركيبةٍ مادِّية تتجاوز به خصائصه غير الماديَّة، تقوم بتفكيكه إلى عناصره
الأوَّلية المادية المكوِّنة له، وتردُّه بكليته إلى مبدأٍ مادِّي واحد.
ولعلَّ - في خضمِّ هذا التوصيف -
يتَساءل البعض: ما هي الفلسفة المادِّية التي
اجتهدَ المسيري في نَقْدِها؟
والجواب على مثل هذا التَّساؤل لا يُشكِّل معضلةً منهجَّية؛ فالذي
تَقدَّم يُمثِّل توصيفًا لأبرز سِمات هذه الفلسفة، فالمادَّة تُمثِّل إطارًا
مرجعيًّا لكلِّ أُطْروحاتِها وأفكارها، وقد تبَنَّى الفلسفةَ الماديةَ عددٌ من
المدارس الفكريَّة ذات الانتشار الواسع، كما هو الحال بالنِّسبة للماركسيَّة
والبرجماتيَّة والداروينيَّة، وتُشكِّل الأخيرةُ عاملاً أساسيًّا في تكريس
الرُّؤية الماديَّة وتأصيلها، فأضحَتْ أكثر المدارس تأثيرًا في العصر الحديث؛
لكونِها رسَّخَت أفكار النموذج المادِّي الواحدي، وجعلَت الإنسان جزءًا من الطبيعة
والمادَّة، لا يستطيع تجاوُزَه.
ومِن المهمِّ أن نؤكِّد في هذا
السِّياق على أنَّ الفلسفة المادية قد فَشِلَت في تفسير ظاهرة الإنسان؛ بسبب
تَجاوُزِها للجانب الأهمِّ منه، وهو ذلك البُعْد الذي يُميِّز الإنسانَ عن غيره من
خلال نشاطه الحضاريِّ الذي جعلَه خليفةً في الأرض، ذلكم النَّشاط المتمثِّل في
نَزْعة التديُّن، والاجتماع الإنساني، والأخلاقيَّات المطلقة، والذَّوق الجمالي،
بالإضافة إلى عَجْزها عن الإجابة عن التَّساؤلات الكُبْرى التي شغَلَت الإنسان منذ
أقدم العصور، وجعلَتْه يتخبَّط في تفسيرها.
وعلى هذا الأساس يقدِّم المسيري
نموذجه التَّوليدي القائم على مفهوم الإنسانيَّة المشتركة، في مقابل الإنسانيَّة
الواحدة الذي دعَتْ إليه الفلسفةُ الماديَّة، وأبرز ما يُظهِر الفارق بين
النموذجين أنَّ الاختلاف في الإمكانيات والطاقات التي يتمتَّع بها الإنسانُ مع
تفاوُتِ وتبايُن الظُّروف والمُلابَسات وتغاير التَّفاعل معها من قِبَل الإنسان
يُفضِي إلى أشكالٍ حضاريَّة متنوِّعة ليست عامَّة؛ لأنَّها لا تُمثِّل قوالِبَ
ثابتة، وهذا يُثبِت بِدَوره أنَّ الإنسان لا يُمثِّل جزءًا لا يتجزَّأ من الطبيعة
الماديَّة؛ بل يمكن تَجاوزُها والتأثير فيها بِما أوتِيَ من قدرات جعلَتْه
مُفضَّلاً على غيره من المخلوقات في حالة إدراكه لِدَوره الحضاريِّ على هذه الأرض؛
قال تعالى: ﴿ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ [هود: 61]؛ فهذا البيان الإلهيُّ دليلٌ صريح على قدرة الإنسان في
تَجاوز طبيعته الماديَّة، والتأثير في مَجاله حيث طُلب منه العمران الحضاريُّ
الجامع للقِيَم العليا دينًا ودُنْيا، مادَّة ومعنًى.
ثانيًا - إشكالية المعرفة:
تُحاول الفلسفة الماديَّة تعميمَ
نموذجها المعرفِي؛ ليكون إطارًا مرجعيًّا معرفيًّا لكلِّ العلوم، ومن المعلوم أنَّ
العلوم دائرةٌ في إطارَيْن: الأوَّل: يندرج تحته ما يُسمَّى العلوم التجريبيَّة (الطبيعيَّة)، والثاني: تندرج تحته العلومُ الإنسانيَّة، وبناءً على مرجعيَّتِها المادية
الكامنة؛ دعَت الفلسفة الماديَّة إلى تعميم قوانين العلوم الطبيعيَّة؛ لتكون
ساريةً على العلوم الإنسانيَّة، منطلِقة من فَرْضيَّة أنَّ قوانين التاريخ
والمجتمع الإنسانيَّيْن تشبه قوانين الطبيعة؛ ولذلك حاوَلوا إثبات صحَّة هذه
الفرضيَّة، واكتشاف القوانين، وصياغتها بطريقة علميَّة دقيقة كمية، وهي بذلك
تُنادي إلى رَفْع شعار وحدة العُلوم؛ بحيث يمكن إدخالُ كلِّ شيء في شبكة السببيَّة
المطلقة، فلا بدَّ من إخضاع كلِّ شيء للتجريب، وعلى هذا الأساس؛ يبدأ تأسيس علومٍ
مُجتمِعة طبيعيَّة أو إنسانيَّة، تستبعد الجوهر الإنسانيَّ، ومفهوم الطبيعة
البشريَّة ذات الثُّنائية المتلازمة، وعند ذلك يمكن توصيفُ ذلك الإنسان الذي تريد
الفلسفة الماديَّةُ صياغته وتنشئته بأنَّه إنسانٌ طبيعي وظيفي آلِي ذو بُعْد واحد،
يدور مع المادَّة حيث دارَتْ، وعند ذلك يُقال: ليس من الصُّدفة أن نرى الفلسفة
الغربيَّة بشتَّى مَدارسها تدعو إلى هذه الرُّؤية التَّفكيكية التي تهدف إلى تصفية
كلِّ الثُّنائيات التي تَجْعل الإنسان يتَجاوز إطارَه الماديَّ، والواقع أنَّ هذه
الرُّؤى إنَّما تبنَّتْها الفلسفة الماديَّة؛ لأنَّها مسلكٌ يَسْهل به تفسير
الظَّواهر؛ إذْ يُمكِن الحصول بشكلٍ سريع على المعلومات عن العالَم المادِّي
وقياسها، والتَّرابطُ المادي بين الظَّواهر أمرٌ يمكن رَصْدُه بشكلٍ موضوعي محسوس،
وحركة المادَّة نتيجتها مباشرة؛ ولذلك رامت الفلسفةُ المادية تعميمَها على
الظَّاهرة الإنسانية ومَعارفها وعلومها؛ حتَّى لا تَلِجَ مداخل الكيان الإنساني ذي
البُعْد غير المادي، فتأتي على مُنطلَقاتِها وأسُسِها الماديَّة بالإبطال، وهي
عقليَّة يُمكن وصفها بأنَّها مستريحة.
ومِمَّا يُستحضَر في هذا السِّياق ما
قاله الإمامُ أحمد بن حنبل - رحمه الله - حينما طلبَ منه أحدُ طُلاَّبه الاستجابةَ
لمطلب المعتزلة بالقول في مسألة خَلْق القرآن آنذاك، فقال: "إن كان هذا عقلك فقد استرَحْتَ"، وهو أمر
ينطَبِق على الفلاسفة الماديِّين؛ فإنَّهم إنَّما خرَجوا من معارف الوحي وعلومِه؛
لأنَّها ذاتُ أبعادٍ مُحيِّرة، يَصْعب معها وَضْعُ تفسيرٍ لِتَساؤلات الإنسان
الكُبْرى؛ ما لَم تكن هناك أخبارٌ صادقة، وعقول مصدِّقة، ولقد نصَّ العلماء على
أنَّ الأنبياء جاؤوا العقول لا بِمُحالاتها.
والواقع أنَّ محاولة تعميم قوانين
العلوم الطبيعيَّة على العلوم الإنسانيَّة باءت بالفشل الذَّريع؛ بسبب الاختلافات
الجذريَّة بين الظاهرة الطبيعيَّة والظاهرة الإنسانيَّة، ويكفينا لإثبات الفارق
وجهٌ واحد فقط مِمَّا ساقه المؤلِّف في كتابه، فنقول: إنَّ الظاهرة الطبيعيَّة
عَرِيَّة عن الإرادة الحُرَّة، والوعيِ والذَّاكرة - في الظَّاهر - فلا ضمير لَها،
ولا شعور، بِخلاف الظَّاهرة الإنسانيَّة، الإنسان فيها يتَّسِم بِحُريَّة الإرادة
التي تتدخَّل في سَيْر الظَّواهر الإنسانيَّة، كما أنَّ الإنسان له وعيٌ يُسقِطه
على ما حوله وعلى ذاته، فيُؤثِّر هذا في سُلوكِه، كما أنَّ له ذاكرةً تَجْعله
يُسقِط تجاربَ الماضي على الحاضر والمستقبل، كما أنَّ نُموَّ هذه الذَّاكرة
يُغيِّر من وعيه بواقعه، وهو بِهذا يثبت عجز الفلسفة الماديَّة في قياس الظاهرة
الإنسانيَّة على الظاهرة الطبيعيَّة بِمَسلك التجريب قاصدةً التَّعميم، ومِمَّا
زاد الفلسفة الماديَّة فشلاً في تحقيق أهدافها ومَقاصدها أنَّ القوانين التي
استندَتْ عليها في العلوم الطبيعيَّة لَم تَعُد ذات قيمة مُطلَقة، فبعد أنْ كان
المادِّي والطبيعي هو الذي يُدرَك بالحواسِّ، وأنَّ ما لا يُدرَك بالحواسِّ ليس
بماديٍّ وليس بِمَوجود أصلاً، أضحى بعض ما في الطَّبيعة - كما يَصِفونها - لا
يُمكن إدراكه بالحواسِّ كما أثبتَتْه الاكتشافات العلميَّة الجديدة، الأمر الذي
أفضى إلى اضطراب الإطار المفاهيميِّ الذي تستند عليه الفلسفةُ الماديَّة، فحاولت
تغييرَ مفهوم (المادِّي) بحسب المتغيِّرات الجديدة، وهو ما على الأصل الذي تَستند عليه.
ثالثًا - إشكاليَّة القِيَم:
الفلسفة الماديَّة، ومِن أجل تَسْويق
أفكارها في مذهبها الفلسفيِّ الَّذي لا يَقْبل سوى المادَّة؛ باعتبارها الشَّرطَ
الوحيد للحياة الطبيعيَّة والبشرية، وكنتيجةٍ للصِّراع بين الكنيسة والعلم، رفضَتْ
فكرة الإله كشرطٍ مِن شروط الحياة، ورفضَت الإنسان نَفْسه إذا كان يعتقد المُجاوزة
للنِّظام المادي، فجعلَتْ كلَّ شيء في العالَم يُرَدُّ إلى مبدأ واحد فقط، هو
القوَّة الدافعة لكلِّ المخلوقات؛ لكونِها دائرةً في إطار التَّسوية الخلقيَّة،
فيَسْتوي الإنسان بِغَيره من الكائنات، وتكون المادة هي الحاكمة للإنسان وطبيعته،
وهنا تَبْرز إشكاليَّة القيمة في هذا الإطار الفلسفيِّ الذي تَدُور معه هذه
الفلسفة، فلا وجود للإله؛ لأنَّه يتَجاوز المادَّة، وليس مَحْسوسًا، فالمَحْسوس هو
الموجود، وما سواه فلا وُجودَ له، وجعَلوا المادَّة تسبق كلَّ شيء، فهِيَ تَسْبق
العقل والأخلاق والتَّاريخ، وحتَّى لو التمَسْنا أخلاقًا في ظلِّ هذا النظام
المادِّي، فإنَّما نقف على أخلاق تُفسَّر تفسيرًا ماديًّا، ووفقًا للقانون الطبيعي.
وهنا يَلْفِت المسيري نظَرَنا إلى
هذه الإشكاليَّة، فيَذْكر أنَّ مَنْطِق الحاجة الطبيعيَّة المباشِرة هو الذي
يتحكَّم في الأخلاق الإنسانيَّة، ولذا تَجْعل المذاهبُ المادية الأخلاقَ محصورةً
في الخيرات الماديَّة فحَسْب، والواقع أنَّ دعوتَهم لِنَفي الإله كان غرَضُه
إلغاءَ كلِّ مُطْلَق كلِّي، والهجومَ على الإنسان؛ من أجل إرجاعه إلى أصل مادَّته،
وهو الطبيعة، وهي دعوةٌ تتَناسب مع مرجعيَّتِهم الماديَّة الكامنة.
ولعلَّ البعض يتَساءل ما وَجْه الإشكال في الفلسفة
الماديَّة في إطار القِيَم الذي يثيره المسيري في كتابه؟
والإجابة عن هذا التَّساؤل تَفْرِض
علينا إدراكَ الإطار المفاهيميِّ للقيم في الأصل، فالقِيَم كما يقول بعض الباحثين
هي: مجموعةٌ من المثاليَّات وضعَتْها حضارةٌ ما، وارتبطَتْ بها وجودًا وعدمًا،
وهذا المعنى الذي يثيره مفهوم القيم يَجْعلنا نقرِّر أنَّ الفلسفة الماديَّة ليس
فيها قيمٌ بالمعنى الذي تَمَّ تحديده؛ لأنَّها دائرة في إطار النِّسبِي؛
فمَرْجعيتها الماديَّة تلغي خاصيَّة الإطلاق، وهذا الأساس بطبيعة الحال يَعْنِي غياب
القيم المطلقة في الحضارة الغربيَّة التي تتأسَّس على الفلسفة الماديَّة، ذلكم
الأساس الَّذي يتناسب مع الشِّعار الذي تستند عليه هذه الفلسفة كما يُعبِّرون عنه
باللُّغة الإنجليزيَّة: (value – free)، حيث تصبح
كلُّ الأمور متساوية، ومن ثَمَّ تصبح كلُّ الأمور نسبية، وعند ذلك لا يمكن التمييز
بين الخير والشَّر، والعدل والظُّلم، بل وبين الجوهريِّ والنِّسبِي، وأخيرًا بين
الإنسان والطبيعة، أو الإنسان والمادَّة، وهو ما يؤكِّد أنَّ مع غيابِ قيمٍ مطلقة
في الحضارة الغربية يُحتكم إليها، يَصْعب - إن لَم نَقُل: يستحيل - وضْعُ حدٍّ
لكلِّ الأزمات الإنسانية بشتَّى أوجُهِها، وانعكس ذلك على طبيعة الحياة البشريَّة؛
إذْ سعَت الفلسفة الماديَّة إلى تعميم أفكارها على اعتبار أنَّ التاريخ الإنساني
يُمثِّل وحدة متجانسةً متجاوزة الخصوصيَّة الحضارية التي تتَّسِم بها كلُّ أمَّة
من الأمم، وعلى هذا الأساس برزَت الدَّعوة إلى مفهوم التقدُّم بإطاره الغربي،
باعتباره انعكاسًا للقانون الطبيعي؛ مِمَّا يؤدِّي إلى التسليم المطلق لكلِّ ما
ينتجه الغَرْب مادة ومعنًى.
من هنا جاءت الدَّعوة الغربيَّة
عالميَّةً من أجل جَعْل المنهجيَّة الغربية نموذجًا يُحتذى، ويُمثِّل نَسقًا
معرفيًّا تستند عليه البشريَّة في تحقيق أهدافها وغاياتها، وحتَّى تضَع الفلسفة
الماديَّة منهجيتَها موضِعَ التنفيذ؛ جاء الهجوم على الطبيعة البشريَّة؛ لِيُمثِّل
برهانًا ودليلاً على مدى تَمسُّكِها بمرجعيَّتِها الماديَّة الكامنة، فجاءَت
الدَّعوة إلى نظريَّة الحقوق الجديدة والتَّمركز حول الأنثى في إطار دعوتِها
العالَميَّة؛ حيث تأسَّست جماعاتٌ للدفاع عن الشواذِّ جنسيًّا والمنحرفين، بل
وأفضى ذلك إلى تقنين الزِّيجات المنحرفة (الذَّكَر بالذَّكر، والأنثى
بالأنثى)، وهذا
الدِّفاع الشَّرس عن الشُّذوذ الجنسي، والدَّعوة إلى تطبيعه، هو في جوهره ليس
دعوةً للتَّسامُح، أو لِتَفهُّم أوضاع الشواذِّ جنسيًّا، بل هو هجومٌ على
المِعْيارية البشريَّة؛ لإلغاء ثنائيَّة الإنسان الأساسيَّة؛ (الذَّكر والأنثى) في إطارها السَّوي، ولَم يقف الأمر
عند هذا الحدِّ، بل أفضى إلى تَسْييس هذه النَّظريات باسم حقوق الإنسان، فالحديث
المُتواصل عنها، وخاصَّة من قِبَل بعض القُوَى الكبرى في السِّياسة الدوليَّة؛
كالولايات المتَّحدة، هو في حقيقة الأمر هجومٌ على الإنسانية وطبيعتها، هدفها
جَذْب الإنسان من بيئته، وجَعْله منعزِلاً عن دينه وقيمه، وأسرته ووطنه؛ لِيَجعلوه
عبدًا لأهوائه، باسْم حقوق الإنسان، ولكنَّهم لَم يتحدَّثوا في مضامينِ شعاراتهم
هذه عن حقوق الإنسان حول وقف تيَّار الإباحيَّة الذي يُصدِّرُه الغرب بكلِّ ما فيه
من بهيميَّة ورذيلة وارتكاس، ولَم يتحدَّثوا عن سرقة أموال الشُّعوب وثرواتِها،
ولا عن الحروب التي تشنُّ فتزهق الأرواح، وتُدمِّر الدِّيار، ويحرق كلَّ شيء باسم
التقدُّم والديمقراطيَّة وحقوق الإنسان.
هذه هي العالَميَّة التي أرادَ
مُنظِّرو الفلسفة الماديَّة الدعوةَ إليها وتطبيقَها، هي في الواقع انعكاسٌ لرؤية
نسبيَّة نابعة من تربةٍ خاصَّة، ومرتبطة بمرحلةٍ مَحْدودة زمانًا ومكانًا، ولِذَلك
كلُّ مُحاولة لِجَعلها عالميَّة من خلال فَرْض نموذجها المادِّي، هذا يعتبر
تعسُّفًا في حقِّ الغير، وإيقاعًا للظُّلم عليه، وهو ما يؤكِّد فشَلَ الفلسفة
الماديَّة في تحقيق أهدافها وغاياتها، الأمر الذي دفَعَ الكثيرين من عُقَلاء الغرب
إلى تَلمُّس حلولٍ خارج إطارها الفلسفي؛ لأنَّها أضحَتْ عامل تقويضٍ وهدْم للطبيعة
البشريَّة، ولَم تستَطِع الخروج بها من أزماتها، فجاءت الدَّعوة في مرحلةِ ما
يُسمَّى: ما بَعْد الحداثة إلى ردِّ الاعتبار إلى القيم، والتأكيد على الأطُر
الأخلاقيَّة التي تجعل الإنسان مميزًا عن غيره، ولكن الإشكال يَبْقى مطروحًا،
ويتمُّ التساؤل حوله:على أيِّ أساس تستند هذه القيم؟
إنَّ غياب الرؤية المطلقة في الثقافة
الغربيَّة جعلَ القيم مَرْتعًا لأُطْروحات لَمْ تستطع الوقوفَ على أساسٍ صلب يُمكن
من خلالِها تعميمُ أفكارها، فالكلُّ يسير في إطارٍ نِسبِي، ولذلك فالحاجة ماسَّة
إلى الاستِناد على أساسٍ مُطلَق يتناسب مع البشريَّة كلِّها، باختلاف عوارضها
وصفاتها، يُمْكن جعله إطارًا مرجعيًّا يُخْرج البشريَّة من أزماتها.
وهذا لا يتسنَّى إلا من خلال خِطَاب
إلهيٍّ مُطلَق، يحتاج إلى تَنْزيل على الواقع، وواقعٍ يَحْتاج إلى ترشيدٍ وتوجيه.
وهذا يستدعي طَرْح المشروع
الإسلاميِّ الحضاري سبيلاً وطريقًا لِنَجاة البشرية من أزماتها، بحيث تتمُّ
الدَّعوة إليه في إطارِ منهجيَّة فاعلة، مؤسَّسة على قِيَم الوحيَيْن، تستطيع
الأمَّة بعد إصلاح هيئتها التأثيرَ على الصَّعيد العالميِّ من خلال توظيفها لجميع
إمكانيَّاتها وقدراتها؛ لتكون قِبْلة الأنظار في معمورةٍ أفسدَها الماديُّون بعد
إصلاحها.